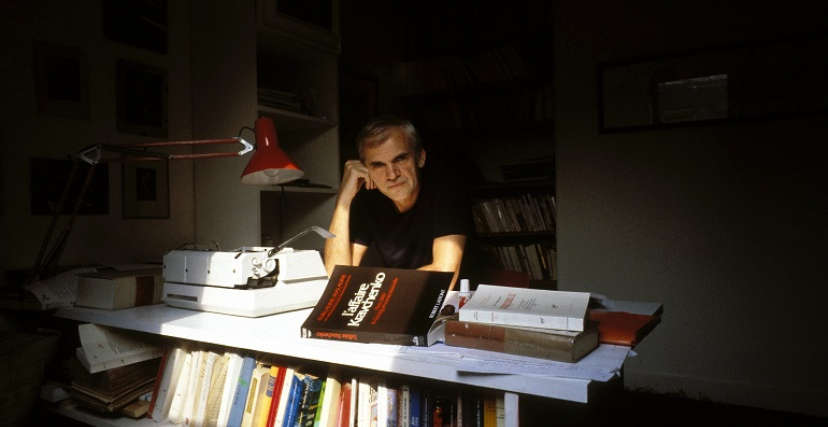تبدو رغبة ميلان كونديرا في جسِّ نبض الرواية المسجى جسدها منذ قرون على طاولة التاريخ واضحة، جنبًا إلى جنب مع فاعليته في فعل التحسس نفسه. ومنذ العنوان الذي سيُعنون به واحدة من أعماله الأشهر، يُشهِّر اختياره للوصف المُحدّد (كتاب) في وجه المتعارف عليه لوصف العمل الروائي نفسه الذي سيتسبب لاحقًا في إسقاط الجنسية عن الكاتب.
ظل كونديرا يدافع عن فكرة الحرية المطلقة للرواية والإيمان العميق بالطاقة التركيبية للرواية
ويبدو العنوان نافرًا كديدن العلامات الفارقة، لا سيما واتفاق الجميع -ومن بينهم كونديرا نفسه- على رؤيتهم لهذا العمل الأدبي الذي حقق أعلى نسبة مبيعات إبّان نشره، كعمل روائي خاضع لما تخضع له توصيفات الرواية. فالكتاب الذي يتكون من عدة قصص تتأرجح في المساحة الشاسعة بين الضحك والنسيان اللذان يُعاد تقديمهما كموضوعات مُشكِّلة للتاريخ بصورة عامة ومخصوصة بفترة زمنية ما بين الحرب العالمية الأولى ونهاية الستينات، يمكن اعتباره توصيفًا دقيقًا لحدود الحرية التي تمنحها الرواية عن طريق الشكل الروائي، حتى وإن كان ذلك خلال إعمال الهدم في بنيتها الآنية.
في مقابلة أجراها التشيكي لصالح مجلة باريس رفيو يقول كونديرا: "يتيح الشكل الروائي الكثير من الحريات، لذلك ينبغي ألا يرى الكاتب أن للرواية شكل من أشكال الحرمة الأدبية والامتناع عن التطوير". ويضيف: "بل على العكس يجدر به تجاوز الهياكل المحددة مسبقًا من بنيتها وتطوير أخرى". وبينما ظل يدافع كونديرا لاحقًا عن فكرة الحرية المطلقة للرواية والإيمان العميق بالطاقة التركيبية للرواية، وعدم ضرورة نبع الوحدة من الحبكة، وإنما من "الثيمة" المطروحة نفسها (الضحك والنسيان)، لا يذهب كونديرا بجسده أبعد من فرنسا في حين كانت عيناه لا تزال في "براغ" المتشككة في كل شيء كما يصفها.
وعندما يصبح كونديرا محكومًا بالمنفى وباستحالة التفاعلية وبوهيميًا ليغدو كأي متغرب يتفقد صلات الوطن بالحاضر، ولكن أيضًا متاحة له فرصة الفرجة على التاريخ، فيذهب إلى أقرب مقعد لمراقبة التاريخ الحاضر لبراغ واستعادة السابق منه. كما سيذهب إلى ما بعد التنظير الأدبي لما يمكن أن نصفه بالمبادرة إلى "تحرير الشكل الروائي". ذلك عندما لم يكتفِ بهذا الشرح المتأخر في رؤيته لفن الرواية، لكنه أيضًا ابتدر مسبقًا مشروعه الأدبي وفق هذه الرؤية.
كما يمكننا القول بأنه ربما قد قام بإطلاق الوعي على أعماق اللاوعي الروائيّ فيه. تعقبَ أثره وتصيّد مكاسبه التي تحققت، منتهيًا في النهاية إلى نتيجة وإلى تفسير وفعل تفهمٍ حاضرٍ وواعٍ بذاته الماضوية.
يغلب على جميع أعمال كونديرا طابع التحديث في الشكل؛ طريقة التقديم، التبويب بالفصول، الأقسام السبعة، القصص الثرية والمتباينة، وتفضيله البعد عن أيّ تسلسل تاريخي صارم، عارضًا بذلك وبجرأة منهجية الشكل الذي يمكن أن تصير إليه الرواية وما تحتمله حدودها بإماطته اللثام عن التطور الذي يمكن أن تحتكم إليه الرواية، ابتداءً من التحرر من وحدة الحبكة وتباعد الشخصيات عن مركزية التاريخ لصالح الاقتراب من وحدة الفعل الإنساني وصولًا الى مكنونات الإنسان.
لا تخلو أعماله من التأملات العميقة التي تتمظهر في صيغة التهكم التي يصبغ بها التاريخ الذي يراه كونديرا بأعين المنفي إلى مركزية أوروبية
كما لا تخلو أعماله من التأملات العميقة التي تتمظهر في صيغة التهكم التي يصبغ بها التاريخ الذي يراه كونديرا بأعين المنفي إلى مركزية أوروبية حينها ليخبرنا بأن التاريخ قد يتمركز حول نفسه ربما ولكن بالضرورة حول الإنسان.
نتيجة هذه الفلسفة توافق حتمية تحول الإنسان وطرْء التغييرات عليه مما سينتهي إلى ضرورة تحول وتطور الأدوات التي من كلياتها تناول الإنسان بالتفسير والاكتشاف.
رفض الشكل الواحد للرواية وإعمال التجديد فيها نفسه جاء عميقًا وفنيًا في المجمل؛ فنجد الموسيقى حاضرةً عند كونديرا لا كشيءٍ عابرٍ، لكن كعنصر من عناصر العمل، وفي استلافه منها لصالح البنية الشكلية للرواية. إذ يستلف كونديرا من معجب طفولته الموسيقية "ليوش ياناتشيك" ثيمة الإحداث في الفن عن طريق إعمال الثورية فيه، مستصحبًا فلسفة الثاني في صنع الموسيقى وتقنياته ليس فقط في عرض "الثيمة" وإنما أيضًا في عرض الإمكانات الكامنة فيها للتطور عن طريق جميع الفاعلين (الشخصيات) في إخراج الأوركسترا.
يستلف كونديرا من معجب طفولته الموسيقية "ليوش ياناتشيك" ثيمة الإحداث في الفن عن طريق إعمال الثورية فيه
محمولًا على العلاقة التي ابتدرت وكونديرا مع الموسيقى منذ الصغر؛ إذ ولد لعالم موسيقى هو "لودفيك كونديرا " ليكون محظوظًا كفاية لتعلم العزف على البيانو من رئيس جامعة جانكيك للآداب والموسيقى حينها. قبل أن يدرس كونديرا نفسه لاحقًا علم الموسيقى والسينما والأدب، ويعمل من ثم أستاذًا مساعدًا ومحاضرًا في كلية السينما بأكاديمية براغ. وربما فسر هذا الميل في كونديرا إلى المشاهد الموسيقية التي يعرضها حين الحكاية. وبالتأكيد لأنه امتلك دومًا الرؤية التي تسمح بتحويل حدث عادي ويومي كجلوس مجموعة من الأشخاص في غرفة إلى عوالم بصرية تُعزف على خلفية الإيقاع الواحد.